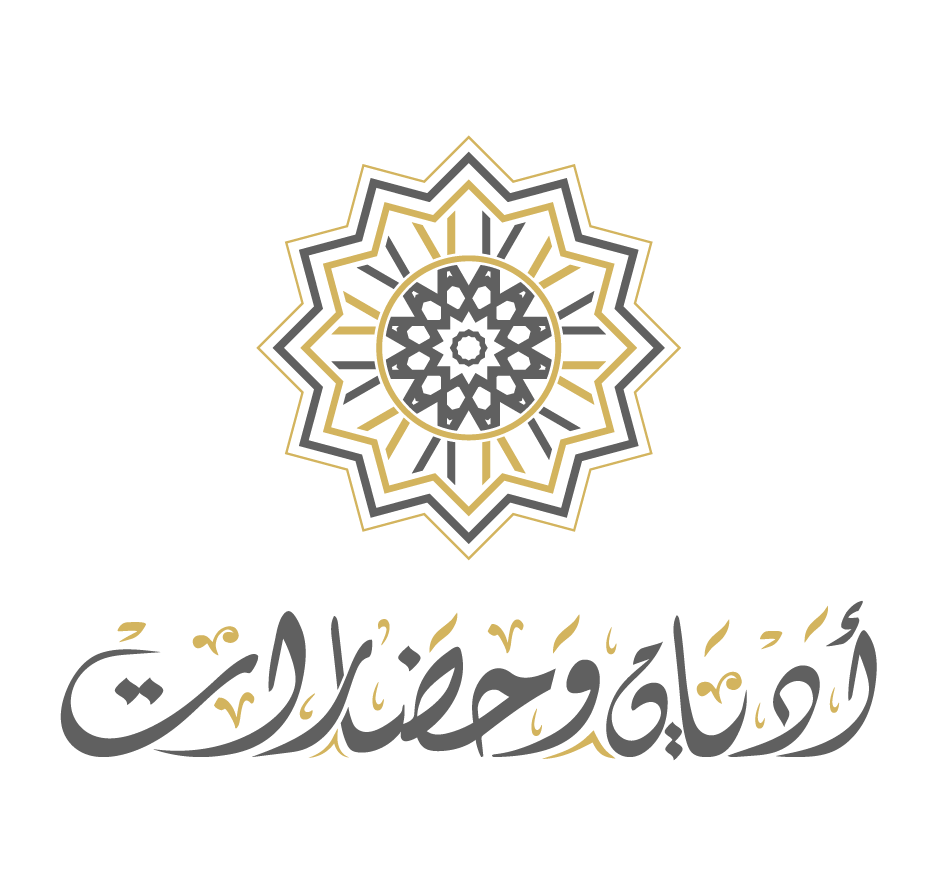لا ريب، أن الاقتصاد ركيزة أساسية وشريان هام لأي نظام سياسي أو دولة على مر التاريخ، فجباية الأموال وحُسن إدارتها وإعادة توزيعها على الرعية، من الأمور الي تعود على الدولة بالإيجاب، وقد نَظَرَ المفكر “ابن خلدون” قبل 400 عام باستقرائه للتاريخ الإنساني، لفلسفة جباية الدولة للأموال ومتى تكون مؤذنه بسقوط الدول. فهل يمكن أن تسقط الدول نتيجة استفحال الضرائب؟
-
جباية الأموال للدولة
لا تخلو الدول من أنظمة جباية الأموال، فهي في طور التأسيس تعتبر قليلة، ولكنها مجزية، وتحديداً في النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يفرض على الرعايا إلا الصداقات من زكاة وخراج الأرض وجزية، وهي في مجملها قليلة لأنها مفروضة بحكم الشريعة العادلة على الناس[1]
الدولة تنشأ في أولها على البداوة ثم لا تلبث أن تنتقل منها للحضارة “ابن خلدون”
ولأن الدولة في طورها الأول إنما هي دولة لا تزال في طور البداوة، ويغلب على طابعها عنصري الغَلبة والعصبية، فلا يزال يسودها صفات البداوة كالتسامح والكرم والجود وخفض الجناح في تحصيل الأموال من الرعايا، وذلك عائد لقلة الوظائف والقوت المحصل منها، فيغلب طابع الهمة والإقبال على العمل وتبدأ الوظائف شيئاً فشيئاً تتزايد نتيجة لتوسع العمران ونشاط الاقتصاد[2]
وكما تقدم، فيحصل أن يتعاظم عمران الدولة، ويبدأ تعاقب الملوك على حكمها، ومع زيادة الوظائف يحصل أن ترتفع الجباية، فيبدأ أفول الصفات المميزة التي امتاز بها المؤسسين من تسامح وكرم وغض الطرف عن الأموال، ومع زوالها، يأتي الملك العضوض المركزي مع الحضارة فتكثر العوائد ويعم الترف والدعة على السلطان والرعية.
-
ولكن هل يبقى نظام الجباية البسيط على حاله؟
بحسب (ابن خلدون) فإن نتيجة ذلك أن تكثر الوظائف وتبدأ الوظيفة السابقة التي كان يؤديها فرد واحد إلى التفرع لتشتمل على وظائف عِدة، وهذا مؤداه لزيادة العوائد من جباية الأموال على الدولة[3] ثم يدخل فصل فرض “المكوس”[4] على جميع البيوع، ومع كل زيادة ترتفع نسبة المكوس على الرعية بشكل تدريجي، حتى تدخل مرحلة لا يطيقها الرعية بسبب الاستفحال، ولا مفر منها لأن زيادتها التدريجية إنما صارت عادة فُرضت عليهم، بل قد ترقى لعرف لا يمكن الخروج عليه لأن الزيادة إنما ارتفعت بشكل تدريجي ولم يستشعروها إلا بعد أن باتت عُرفاً في النفوس[5]
-
المكوس مؤذنة بسقوط الدول وخراب العمران؟
إذا صار العامل يعمل شهراً كامل فيحصل على 100 درهم ويخصم منه المكس 60 درهم، فهل سيعمل في وظيفة عامة؟ كما يورد (ابن خلدون) فإن من شأن ذلك أن يولد غبطاً لدى الرعية، فلا يعد هنالك رغبة عند كثير منهم للانخراط في الوظائف لزوال الأمل في النفوس لقلة العائد، وهذا ما يؤدي بالنتيجة إلى قلة الجباية في خزائن الدولة، وقد تعوض الدولة ذلك بزيادة الوظائف ظناً منها أن ذلك سيرفع الجباية، ولكن الواقع أن ذلك سيزيد من الانفاق وستصبح كل وظيفة زائدة دون نفع عائد على الاقتصاد، فيختل العمران ويبدأ بالتناقص، ويعود ذلك بالضرر على الدولة، وبحسب (ابن خلدون) فإن قلة الوظائف ينعكس على زيادة العمران[6] وبالنظر إلى واقعنا المُعاصر، فإن كثيراً من الوظائف العامة في الماضي كانت قليلة ولكنها ذات مردود نافع، لأن نشاط الفرد مُركز على أداء ما يؤكل إليه طوال مدة العمل وهذا مدعم لنشاطه وعطاءه، بخلاف اليوم، فعلى سبيل المثال: الوظيفة التي كان في الماضي يقوم بها شخصين، أصبح اليوم يؤديها ربما 10 ولكن دون نتيجة أو أية جدوى تذكر، لأن حصيلة الوقت المستغرق في الغالب، إنما يكون مُهدراً في غير أداء العمل أو الالتزام الأصلي وهذا ما يُطلق عليه اليوم “البطالة المقنعة”[7]
لم يكن بيت مال المسلمين في العصور الأولى للإسلام يجبي إلا الصدقات وأصناف الزكاة مما يخرجه المسلمين عن الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وما يخرج من الأرض والتجارة، ولم يوجد تنظيماً للضرائب إلا الجزية بشروطٍ عِدة
-
إنقاذ الدول من الإفلاس كيف يكون؟
لما كانت زيادة الجباية ناتجة عن ارتفاع نسبة الدخول، وإذا كانت خزينة الدولة لا ينمو دخلها ولا يوزع إلا بالجباية، فإن مشاركة الدولة للرعية بالتجارة ينتج عنه إضرار بالعباد وفساد للجباية، لكون خزينة الدولة لا يتعاظم دخلها إلا بزيادة دخول الرعايا وازدهار تجارتهم وينعكس ذلك على الجباية، وبمشاركتها الرعية للتجارة فساد للتجارة وكساد لها، ولا يستقيم حال الدولة إلا بالعدل في الجباية وفي توزيع الأموال[8] وكما أسلف (ابن خلدون) فلا سبيل لإنقاذ الدول اقتصادياً إلا بالعدل في الجباية والعدالة في توزيعها، والكف عن الظلم لما لهُ من مزالق لهلاك الدول، فإذا عم الظلم في أموال الناس ذهبت آمالهم في الكسب والتحصيل، وكفت أيديهم عن السعي[9]
قائمة المصادر والمراجع:
[1]. يُنظر: عبدالرحمن بن محمد: الإشبيلي المعروف بـ “ابن خلدون” (732هـ/808هـ)، ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر “تاريخ ابن خلدون”، ت: أبو صهيب الكرمي، (عَمان: بيت الأفكار الدولية، د.ط، د.ت)، ص140.
[2]. يُنظر: المصدر السالف: ص140.
[3]. يُنظر: المصدر ذاته، ص140.
[4]. المكوس: جباية أموال أو ضريبة يحصلها الماكس دون وجه حق، وتعتبر مُحرمة في الإسلام، لأن الماكس يأخذ مالاً لا يملكه ليقدمه لمن لا يستحقه، والمكوس تختلف عن الضرائب المعتدلة المفروضة نظير خدمات حقيقية لتحسين وتنظيم أوضاع الناس.
[5]. يُنظر: المصدر ذاته، ص141.
[6]. يُنظر: المصدر ذاته، ص141.
[7]. البطالة المقنعة: توظيف عدد كبير من العاملين أكثر من المطلوب لأداء عمل معين. وقد تأخذ شكلاً من الإجراءات الطويلة والمعقدة التي لا نتيجة مرجوة منها لأداء عمل معين رغبةً في توظيف عدد أكبر للقيام بهذه العملية. ويمكن كذلك أن تأخذ شكل السعي وراء العائد من خلال توظيف أكبر عدد ممكن وغالباً ما يكون ذلك بالدول الغنية أو الدول ذات الأنظمة الضريبية التي يقوم عليها الاقتصاد، ولكن بالنتيجة فكل هذه الحالات تؤدي لتدهور الاقتصاد العام وفقدان الدول لإيراداتها، لأنها لا تخلق عائد فعلي للدول.